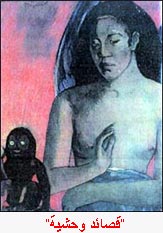|
بول غوغان.. فان غوخ حياة مأساوية وصداقة مثخنة بالجراح
|
|
|
أديب كمال الدين كانت صداقة الرسامين الشهيرين بول غوغان وفان غوخ صداقة معذّبة كحياتيهما المعذبة. عاشا معاً في آرلي بجنوب فرنسا وصارا يقتربان إبداعياً لينجزا فناً اعتبر، فيما بعد، عظيماً. لكن اللقاء، للأسف، لم يكن سارّاً البتة. ولد بول غوغان في باريس عام 1848 من أب فرنسي وأم من البيرو. وهرب من المدرسة وهو في السابعة عشر من عمره. وجاب البحار كملاّح لمدة ست سنوات، وجعلت الحياة الخشنة من الصبي الضعيف شخصاً قوياً، ومنحته، قبل كل شيء، الحلم الذي قدّر له أن يغيّر حياته. يقول كريم الشيخ إسماعيل آل كاشف الغطاء في كتابه «عباقرة الفن»: كان غوغان يجلس على ظهر السفينة ذات يوم عندما سمع بحّاراً من زملائه يصف الحياة في البحار الجنوبية ويقول إن النساء هناك جميلات مطيعات، والفاكهة تتساقط من الأشجار، والشمس تسطع أشعتها كلّ يوم، والليالي تفيض بالسحر، وسجل غوغان في ذهنه ملاحظة لم ينسها مطلقاً. وعندما عاد بول إلى باريس وهو في الثالثة والعشرين من عمره، اكتشف في نفسه موهبة غريبة لفنان مفطور على الإبداع، موهبة الربح من العمل في سوق الأوراق المالية.. ولكي يتوّج حياته كأحد أفراد الطبقة الوسطى المتمسكة بالتقاليد تزوج من ابنة موظف حكومي دنماركي. كانت «ميت كول» شقراء، باردة، عملية، ترتدي الملابس المناسبة وتعد الشاي المناسب للأشخاص المناسبين، وأنجبت لزوجها خمسة أطفال، ولكن بول غوغان كان قد اكتشف يومئذ حبه للرسم. وسرّت الزوجة في البداية، إذ وجد معيلها الطيّب هواية تثير البهجة فليس هناك ضرر في أن يكون «رساماً يوم الأحد». ولكنها لم تدرك إلا فيما بعد ان زوجها رجل لا يرضى بأنصاف الأشياء. وعُرِضتْ أحدى لوحاته، وكانت تسمى «دراسة لفتاة عارية» و«كان نموذجه فيها هو خادمة الأسرة». فوصفها أحد النقاد بأنها أروع لوحة لفتاة عارية منذ «رامبرانت». وبدأت حياة بول غوغان في ميدان الأعمال تبطيء شيئاً فشيئاً حتى توقفت. وترك مكتب السمسرة وهو في الخامسة والثلاثين من عمره، ومنذ ذلك الحين كرّس نفسه للرسم. وفي خلال عام واحد أصبح مفلساً تماماً، فبيع منزل الأسرة بأثاثه الجميل وسجاجيده الفاخرة، وعادت زوجته «ميت» إلى الدنمارك حيث تجد الأسرة على الأقل ما يكفي لطعامها. وتبعها غوغان وسخر الدنماركيون منه باعتباره رجلاً يعيش عالة على زوجته، كما سخروا من لوحاته، وعاد إلى باريس دون زوجته «ميت».
أما فان غوخ فقد ولد عام 1853 في عائلة هولندية اختصت في تجارة اللوحات الفنية. لكن روحه المرهفة وقلبه الحساس قاداه دوماً من محنة إلى أخرى، ومن بلوى إلى بلوى. كانت محنته الأولى حين أحبّ «أور زولا» الفتاة التي رفضت حبه، فقرر، كرد فعل لما حدث، أن يطلّق الدنيا وينتظم في سلك رجال الدين. هكذا أصبح واعظاً يلقي المواعظ على عمال المناجم مناصراً لهم في عملهم الشاق. لكنه فصل من عمله فهام على وجهه، ثم قرر أن يترك المدينة ويتجه إلى الريف. وطاب له العيش في الريف بين التأمل في طبيعته الساحرة وتسجيل مختلف المشاهد والمشاعر، كما يقول مؤلف كتاب «عباقرة الفن» ويضيف: بقي فان غوخ شهوراً يقتات طوال يومه بلقيمات يتصيّدها هنا وهناك، غير مبال بما بدأ يظهر على هيئته من بوادر السقم والهزال. ثم أصبح يوماً فاذا هو لا يستطيع النهوض لشدة ما اعتراه من ضعف وخمول. ولاح له أن قد حانت منيته. ولكن نبأ مرضه وصل إلى «ثيو» أخيه الذي سارع إلى إسعافه واستطاع أن ينقذه من المرض والفاقة معاً. إذ اتفق معه على أن يصوّر لحساب متجره بعض اللوحات. وهكذا قدّر للفنان أن يستقر لأول مرّة في حياته. فاتخذ لنفسه مرسماً متواضعاً في المدينة، وكان في حاجة إلى نموذج «موديل» فوجد ضالته في «كرستينا» غاسلة الملابس ذات الاطفال الخمسة التي قدّرت له أن وقاها من التشرد وأطعمها فأخلصت له الود واستمرت تؤنس وحشته، وتعدّ طعامه وتغسل ملابسه وتنظّم مرسمه وتجلس الساعات الطوال أمامه ليتخذها نموذجاً لرسومه، كل هذا لقاء قروش معدودة عن كل يوم تزوره فيه! ولكن الأقدار ضنّت على الفنان حتى بهذا النصيب الضئيل من الاستقرار، فسرعان ما تركته «كرستينا» إلى غير عودة حين علمت بأن عمّه وأخاه هدداه بقطع صلتهما به لما بلغهما من اعتزامه الزواج منها. ومضى الفنان وحده إلى «فيرون دي كوليرانس»، حيث التقى مرة أخرى بالفتاة «راشيل» ذات العينين الزرقاوين الواسعتين. وكان قد خطب ودها حين لقيها لأول مرة في «ارليس» فسخرت منه حين أدركت انه لا يملك شيئاً وقالت له: «على كل حال تستطيع أن تبعث إليَّ إحدى أذنيك الكبيرتين لأحتفظ بها تذكاراً منك». وشدّما كان ذعرها حين فوجئت به في هذا اللقاء وقد أحيط وجهه ورأسه بالأربطة والضمادات وقدّم لها ربطة كان يحملها فلما فتحتها وجدت فيها أذنه مقطوعة كما طلبت منه عابثة. سقطت المسكينة مغشياً عليها وأصابتها بعد ذلك صدمة عصبية لازمتها طويلاً! عيش مشترك ذهب غوغان إلى آرلي بجنوب فرنسا وهو لا يزال مفلساً ليعيش مع صديقه فان غوخ وقام بتمويل هذه الزيارة «ثيو» شقيق فان غوخ، تاجر اللوحات الفنية الذي كان يأمل أن يساعد غوغان فان غوخ التعس نصف المجنون، عاش الرجلان معاً أول الأمر في سلام. وكان غوغان ينظف المنزل ويطهو الطعام وساعد فان غوخ على تنظيم أوقاته كما ساعده في رسوماته. لكن أمزجة الصديقين وآراءهما كانت متعارضة تماماً. وأخيراً أعلن أنه مضطر لتركه وكان في ذلك الكفاية لدفع فان غوخ، الذي كانت تسيطر عليه غريزة التملك، إلى الجنون. في ذلك المساء بينما كان غوغان يسير في الشارع، سمع وقع أقدام خلفه. وهناك رأى فان غوخ على وشك أن ينقضّ عليه ومعه موسى مفتوحة ولم يهاجمه. أي فان غوخ. ولكنه بدلاً من ذلك عاد إلى منزله، وقطع إحدى أذنيه وأخذها إلى فتاة في ماخور، أي راشيل. وأدخل فان غوخ، فيما بعد، أحد المستشفيات وبعد أقل من عامين أطلق فان غوخ الرصاص على نفسه. حقاً كانت تجربة فان غوخ مع غوغان فاشلة، بل قاتلة، كما يقول هنري ميللر في كتابه «رامبو وزمن القتلة ـ ترجمة سعدي يوسف». ويورد ميللر نص رسالة بعث بها فان غوخ إلى شقيقه في يوليو 1880، رسالة تغوص إلى قلب الأشياء، رسالة تستثير الدم. في هذه الرسالة يدافع فان غوخ عن نفسه، ضد ما رمي به من عطالة. وهو يصف، بالتفصيل، نوعين من العطالة: النوع الطالح، والنوع الصالح. والرسالة موعظة حقيقية حول الموضوع، تستحق العودة اليها مراراً وتكراراً: «هكذا، ينبغي ألا تعتقد بأنني أتنصّل من الأشياء. إنني، بالأحرى، مؤمن بعدم إيماني، ومع هذا التبدل، إلا انني الشخص نفسه، وهمّي الوحيد هو: كيف أكون نافعاً في العالم، ألا أستطيع أن أكون في خدمة هدف، وأؤدي أيّ نفع، كيف أتعلم أكثر، وأدرس، بعمق، مواضيع معينة؟ أنت ترى، إن هذا هو ما يشغلني باستمرار، ثم أحس بنفسي سجين الفاقة، مبعداً عن المشاركة في عمل معين..وثمة أشياء ضرورية لا أستطيع بلوغها. إنه أحد الأسباب التي لا تتركني بلا كآبة، ثم ان المرء ليحس بالخواء حيث ينبغي أن تكون صداقة، وحناناً قوياً جاداً، ويشعر بتثبيط رهيب ينهش حتى طاقته المعنوية، ويبدو أن القدر يضع حاجزاً أمام غرائز الحنان، ويتعالى طوفان من الغثيان ليخنق المرء حتى ليهتف: «إلى متى.. يا الهي؟».. ثم يمضي إلى التمييز بين الإنسان العاطل بسبب الكسل، بسبب انعدام الشخصية، بسبب حطّة الطبع، والنوع الآخر من الإنسان العاطل، وهو العاطل بالرغم من نفسه، المتحرق في داخله إلى العمل، والذي لا يفعل شيئاً لأن من المستحيل عليه أن يفعل أي شيء... وهكذا. إنه يرسم صورة الطائر في القفص المذهب. ثم يضيف هذه الكلمات المؤثرة المنذرة: «وغالباً ما تمنع الظروف الناس من عمل الأشياء، إني سجين قفص لا أدري كم هو فظيع فظيع فظيع. وهناك أيضاً، وأنا أعرف الأمر، إطلاق السراح، إطلاق السراح المتأخر. السمعة السيئة حقاً أو باطلاً، البؤس، الظروف المميتة، العداء، كل هذه تسجننا، بل تدفننا، لكن المرء يحس، من ناحية ثانية، بحواجز معينة، وبوابات معينة، وجدران معينة. أكلّ هذا خيال وفانتازيا؟ لا أظن ذلك. ثم يتساءل المرء: «الهي، أيظل هذا طويلاً ابدياً، خالداً؟» أتدري ما الذي يحرر الإنسان من السجن؟ إنه كل حنان جاد عميق: ان نكون أصدقاء، أشقاء، أن نحبّ بعضنا، هذا الذي يفتح السجن بقوة عليا، قوة سحرية. لكن بدون هذه القوة يظل السجن باقياً. حيثما تجدد العطف استعيدت الحياة». حنين مزدوج إذا كان فان غوخ قد مزقه الحنين إلى الحب، إلى الحنين، إلى الاتحاد بالمرأة، حيث كانت المرأة معه، كما رأينا بوضوح، قاسية، فظّة، جلفة بأسمائها المختلفة وأجسادها المنوّعة وعيونها التي لا ترى أكثر من الأنف، فان بول غوغان عذّبه حبّه الحيّ لزوجته «ميت كول». فهي لم تغادر روحه رغم انفصالهما لسنين طويلة. بل بقي حبّها يطارده وهو يتنقل من سنة إلى أخرى، ومن مدينة إلى أخرى، ومن بلد إلى آخر، ومن لوحة إلى أخرى، ومن الأحمر إلى الأخضر إلى الأسود إلى الرمادي المتدفق ذكريات وذكريات. كتب إليها من تاهيتي بعد انفصالهما بخمسة عشر عاماً يقول: «أحبيني كثيراً لأنني عندما أعود سنعود حبيبين من جديد. انني أبعث إليك قبلة عاشق وعناق زوج». لكن هذه العواطف الصادقة العميقة لم تجد نفعاً مع «ميت كول» الشقراء، العملية، القاسية. يقول كريم الشيخ إسماعيل: عاد غوغان إلى البحار الجنوبية حزيناً. وهو في السابعة والأربعين ليعيش السنوات الاخيرة البائسة من حياته في تاهيتي أولاً ثم في جزيرة دومينيكا النائية. وكان قد أصيب بالزهري الذي لم يكن له علاج في تلك الأيام، كما كان مصاباً بجرح مفتوح في كاحله يأبى أن يندمل. وقاسى آلاماً شديدة وكتب يقول: «إنني أنتظر هنا كفأر في برميل وسط المحيط».. إن الكثيرين منا يتخيلون غوغان قد استلقى تحت الأشجار، وحسان جزر البولينيين ويرقصن لتسليته. ولقد كان يستلقي فعلاً، لأنّ ساقيه أكلهما المرض حتى أصبح عاجزاً عن المشي. وإذا كانت الفتيات قد غنين له فذلك لأنه كان قد بدأ يفقد بصره!. وقال لأحد الأطباء «كادت تخبو أنواري». لقد كان أنظف الرجال وأكثرهم اناقة. ولكنه كان وحيداً لا يستطيع أن يعتني بنفسه، ومات عام 1903 في كوخ قذر من الخوص بجانب آخر لوحاته وهي تصوّر منظراً للجليد في مقاطعة بريتاني.
وبعد سنوات من وفاته، عندما أصبح اسمه اسطورة، مثل اسم زميله التعس «فان غوخ»، بدأ التهافت على جميع لوحاته. ووجدها هواة جميع التحف في الحانات والمواخير والمساكن المفروشة، حيث قايض عليها مقابل متطلبات الحياة اليومية أو اقامة يوم. وكانت قد وضعت في الغرف العليا أو المخازن لأن أصحابها لم يكونوا يرون أنها جديرة بتعليقها على الجدران. أما في بريتاني فقد استخدمت كحصائر أو لصنع أحذية من أقمشتها! لقد حاول غوغان قبل وفاته بفترة غير طويلة أن يشرح في تقرير مكتوب يتسم بالايمان عن حياته الغريبة التي تنطوي على مأساة فكتب يقول: «إنني أعتقد أن الفن مصدر إلهي يعيش في قلوب جميع الرجال الذين مسّهم النور السماوي، وما ان يتذوق الإنسان متع الفن العظيم، حتى يكرّس نفسه له إلى الأبد دون أن يستطيع الفرار منه». إذا كانت الانطباعية قد اهتمت بتصوير العالم المرئي المباشر بطريقة جديدة تقوم على التجربة الذاتية للفنان، فإن مجموعة من فناني القرن التاسع عشر «أمثال: غوغان، وسيزان، وفان غوخ» ذهبوا في اتجاهات آخرى كما يقول د. محمود أمهز في كتابه «التيارات الفنية المعاصرة» ويضيف: كان بعضهم قد حاول ان يطبق في التصوير ما قاله بودلير: «اريد حقولاً بالأحمر، وأشجاراً بالأزرق، فليس للطبيعة من مخيلة». وقد تحققت هذه الرغبة مع غوغان عندما تخلّى عن اللون كما هو في الطبيعة، ورفض عوائق المشابهة، ثم انتقل، بعد ذلك، إلى اللون الاصطلاحي كما طالب به بودلير. واستخدام الألوان الاصطلاحية يتناقض مع الغاية التي كان يسعى غليها مونيه، ويلخصها بقوله: «أرى هذا البيدر بنفسجياً عند الغسق، فأصوّره، اذن، بنفسجياً على لوحتي، بينما يصوّره غوغان، سواء أكان أصفر أم بنفسجياً باللون الأحمر إن أراد. ويبدو أن طبيعة حياته الخاصة قد تركت أثرها على نتاجه الفني وأسهمت في تحديد مساره. فهو من أب فرنسي وأم من البيرو، نشأ في البيرو واحتفظ طيلة حياته بحنين للبلاد الأجنبية، فذهب إلى بريطانيا، ثم المارتينك، وتاهيتي، والدومنيك، تدفعه إلى ذلك «حاجة للهرب من نفسه، من عالم يسحقه وحاضر يجرحه». اختلافات بارزة الآن، ما هي الاختلافات الأبرز ما بين هذين الفنانين الكبيرين؟ يجيب مؤلف كتاب «التيارات الفنية المعاصرة» فيقول: إن عالم فان غوخ المضطرب يختلف عن عالم غوغان الخيالي الهادئ، تحركه الضربات اللونية المنفعلة والخطوط المتموجة المتكسرة، المعبرة عن حس داخلي عميق وعن ألم نفسي ينعكس في جميع أعماله «المناظر أو الصور الشخصية». وكان فان غوخ، بعد أن جاء إلى باريس في السنة «1886» التي أقيم فيها المعرض الثامن والأخير للانطباعيين، قد أعجب بألوان هؤلاء الفنانين الفرنسيين وتأثر بهم، كما تحولت ألوانه لتصبح زاهية متألقة بعد أن كانت مظلمة قاتمة في البداية. وبفضل هذا الاحتكاك المباشر مع المصورين الباريسيين، اكتشف فان غوخ التصوير المناخي بدقائقه وترجرجاته الهوائية والانعكاسات الضوئية المتبادلة بين الأشياء ومحيطها. ولكن رغم تأثره بالانطباعية فإنه لم يكن انطباعياً كما يرى د. محمود أمهز. إن أعماله، حسب هذا الرأي، جاءت لتشكل بدورها رد فعل تلقائياً ضد اتجاهاتها وأهدافها. لم يكن فان غوخ أقل اهتماماً من الانطباعيين بالضوء والتألقات اللونية. لكن الضوء. كما تعكسه معظم أعماله الاخيرة، هو ضوء الشمس الساطع، شمس الجنوب الذي أعجب به، لا الضوء الرطب الندي، المبلل لدى الانطباعيين. وألوانه نقية، صافية، واضحة، لم تقتصر على تسجيل اللحظة العابرة، أو الحس المادي كما فعل الانطباعيون، بل هي تجسيد لقيم رمزية وتعبيرية، تطفح بمشاعر إنسانية تصل إلى أقصى حدود المأساة. وللتعبير عن هذه المشاعر الإنسانية يختار الفنان الألوان الاصطلاحية الملائمة غير المقيدة بالعالم المرئي. ويشرح ذلك بقوله: «بدلاً من أن انقل ما هو أمام ناظري، فإنني أستخدم اللون اصطلاحياً للتعبير بقوة عن نفسي». أي انه يستخدم هذا اللون ليصف «الانفعالات الانسانية» متخطياً كل مفهوم وصفي أو صوري للشيء المرئي. وهنا فإن كمية من اللون الأحمر او اللون الأخضر تكفي للتعبير عن حالات من الفرح أو الكآبة. هكذا، فإن فان غوخ، وبعد أن فشل في حياته الخاصة، وعجز عن القيام بأيّ دور اجتماعي كان يتمناه، حتى كواعظ كهنوتي، قد نجح في هذا الدور من خلال عمله الفني الذي ينيره شعور داخلي، شعور إنساني عميق. على المستوى الحياتي، كانت الصداقة الغوغانية الفان غوخية وبالاً حقيقياً. فالفقر والجوع والحرمان الجهنمي والضياع الروحي المخيف، كل ذلك فعل فعله لتنقلب الصداقة ما بين هذين الرسامين إلى عداوة، فمحاولة قتل. بل إن فان غوخ قطع أذنه ثم انتحر فيما بعد. أما غوغان فانتحر هو الآخر ولكن بطريقته الخاصة، ذلك بأن أسلم نفسه، طواعية، إلى الأقاصي والمنافي البعيدة والمرض والعمى. لقد أسلم نفسه إلى الموت بطريقة أطول نفساً. لم يكن اللقاء، إذن، سعيداً على الاطلاق. رغم أن غوغان وفان غوخ التقيا إبداعياً وفنياً ولونياً. لكن الروح حين ترتبك تحت وطأة الأحوال اللاإنسانية يضيع كل شيء ويتهدم كل شيء. هكذا انتهت مسرحية اللقاء الانطباعي الغوغاني الفان غوخي الشهير، ليظهر لنا الخراب وهو يضحك آخر المطاف، بل ينفجر من الضحك. الأدهى من ذلك، انهما وقد عاشا حياتهما وسط فقر أسود، وجوع مخيف، وشظف عيش لا يوصف، تحولا، بعد موتهما، إلى ثريين عظيمين، بعد أن أخذت أعمالهما بتحقيق أسعار أسطورية! نعم، حدث ذلك بعد أن تحوّل الفنانان الشهيران إلى أسطورتين بكل ما في الأسطورة من معنى! |
|