|
يكتب أديب كمال الدين قصائده على
خلفية ثقافية صوفية، فهو شاعر متصوف،
وليس متصوفاً شاعراً، يعبّر عن تجربته
الصوفية بالشعر. وسبق أنْ ذكرتُ، في
دراسة سابقة عنه، أنّ قصائده لا تنبثق
من تجربة صوفية بقدر ما تنطلق من
ثقافة صوفية. ومع ذلك، فإنّ هذه
القصائد تحاول أنْ تبني تصوراتها من
خلال تلك الثقافة. فقصائده، لا تنتمي
إلى جنس الشعر الصوفيّ، وإنما تحرّرت
من قيود الحدسية والمثالية في التجربة
الصوفية الخالصة التي تستسلمُ فيها
الروح والعقل إلى تلك القوة
الماورائية التي تتلاعب في عمليات
الإدراك الفيزيقية لتربطها بما يُسمى:
قوة العلم اللدنيّ، وجعل الذات تتسامى
عَبْرَ نشاط حضوريّ مكثّف بالانسلاخ
عن اللحظة التاريخية والانقذاف في
اللحظة المتعالية. وفي الوقت الذي
تحررت فيه تلك القصائد من تلك القوة
المغيِّرة، فإنها استعادت جزءاً من
مَلَكة الإدراك الطبيعيّ، وحاولت أنْ
تؤسس ما يمكن تسميته: الصوفية
الواقعية، وهي التي لا تريد أنْ تقف
على التخوم أو أنْ تختار مكاناً قصياً
عن الواقع، بل تنخرط في تجاربه،
وتنقذف في أتون تلك التجارب، فهذه
القصائد تريد أنْ تصل إلى الحقائق كما
هي في الحياة، التي تغدو مصدراً
للحقائق ومنبعاً للإلهام. فالحياة
مفعمة بالشعر، لذلك فإنّ التبصرات
الصوفية في هذه القصائد تتخطى مرحلة
الخضوع والانخطاف والذهول والإنصات
لنبوءات متشائمة حول الفناء والحياة
والإنسان والعالَـم. وبالتحرر من خطاب
الشفقة على النفس، والتحرر من
التوترات السلبية التي تنشغل بالعدم،
فإنّ الشعر يمكن استثماره في النفاذ
إلى أعماق الحياة بحثاً عن لحظة عناق
حقيقيّ بين الذات والواقع، فليس ثمة
"يأس مما في أيدي الخلائق" كما يقول
معروف الكرخيّ، وإنما ثمة أمل في قدرة
الشعر على التفاعل مع الخلائق [قصائد
أديب كمال الدين حول: البريكان،
البياتي، يوسف الصائغ، جان دمو، عفيفة
إسكندر، عبد الحليم حافظ، شارلي
شابلن، مطرب بغدادي، شهرزاد، مهند
الأنصاري، فيروز، وغيرهم] باعتبارهم
أصواتاً إنسانية من لحم ودم، عاشوا في
ظروف مختلفة، لكنهم يلتقون في طبيعة
المحنة الإنسانية الواحدة. ولذلك،
اختلفت طرائق تصويرهم لتلك المحنة.
وقصائد أديب كمال الدين عنهم، تحاول
أنْ تقتبس إيقاع تلك المحنة في
حيواتهم وطرائق سلوكهم. ولذلك، فإنه
لا يهمل صوت الإنسان الجارح والجريح
في آنٍ، بخلاف الأدب الصوفيّ الذي
يذيب الأنا والآخر في الذات المتعالية
بغية التماس حقيقة تبقى عصية المنال
إلى حدّ المستحيل، على حين يتعامل
أديب كمال الدين مع الآخر/الإنسان
باعتباره جزءاً من المشهد الذي لا
يمكن تجاوزه أو الاستغناء عنه:
هذه أغنية أعددتُها لكَ،
أغنية بسيطة جدّاً
وقصيرة جدّاً.
أغنية تتحدّثُ بشوقٍ كبيرٍ عن الحاء
والباء،
وتحاولُ بإصرارٍ كبيرٍ أنْ ترسمَ لها
جناحين
وعشّاً في آخر المطاف،
عشّاً يكفي لبيضةِ طائرٍ منفيّ
لا اسم له ولا عنوان.
فهذا النوع من الخطاب، يصحح نظرة
الصوفيّ إلى العالَم، من نظرة سلبية
تنظر إليه عن بعد فتجده عالماً فاسداً
وناقصاً لا يمكن إصلاحه وخير نقاء منه
هو الفناء، إلى نظرة إيجابية تحاول
معرفته وإصلاحه، وهذا ما يغير أيضاً
وظيفة الشعر التي كانت مقتصرة على
فناء اللغة والشعر والشاعر في
العالَـم، إلى الغوص في أعماقه ومعرفة
أسراره من الداخل. وقد عبّرت قصيدة:
أغنية إلى الإنسان، عن هذا المنحى
الجديد الذي يريد أنْ يذيب الحدود بين
الشاعر والمتصوف إلى حدّ التوحّد.
فهذه القصيدة، وهي واحدة من قصائد
عديدة تعبّر عن هذا المنحى، لا تُعرِض
عن المشكلة بالانكفاء على الذات،
وإنما تتوجه إلى الإنسان لتحريره من
الخوف من خلال الحب. ولذلك فهي مثل
تلك الأغاني/القصائد التي عُرفتْ في
الأدب الملتزم ذي الخلفية الماركسية
ولاسيما عند السياب والبياتي وغيرهما،
تقف مع الإنسان وتعاضده بغية انعتاقه
من التعسف والتسلّط. فهي قصائد ثورية،
غايتها تحريض الإنسان على الرفض
والتمرد، وقصائد تحتفي بالانتصار
بالمعنى الفرديّ الذي يتحرر فيه الفرد
من القيم الزائفة للجماعة.
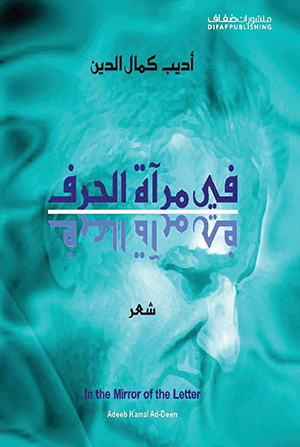
حتى قصائد الحب عند أديب كمال الدين،
ليست مجرد تصورات متعالية كما في
الأدب الصوفيّ التي تجعل الاثنين
واحداً: "أنا من أهوى، ومن أهوى أنا"،
بل هي تعبّر عن تجربة تنتمي إلى
عالمنا الأرضي، ومصدر هذا الحب هو
الحياة والواقع، لا كما قال معروف
الكرخيّ عندما سُئِلَ عن مصدر الحب،
فأجابَ: "ليست المحبة من تعليم الناس،
المحبة من تعليم الحبيب".
يشدّد الأدب الصوفيّ على أولوية
البصيرة إلى الحدّ الذي ينزوي فيه
البصر بعيداً عن ممارسة دوره الحقيقي
في المعاينة والإبصار، فالمتصوفة
يعتقدون إذا "انفتحتْ عينُ بصيرة
العارف، نامت عينُ بصره". لكنّ هذه
القصائد مرتبطة بزمان ومكان وشخوص
حقيقيين:
كانَ هناك بعض المخلوقاتِ الآدميّة
قربَ هذا النهر السحريّ
لكنّ هذه المخلوقات قد تبخّرتْ
أو انتحرتْ أو احترقتْ
في الحروبِ التي حاصرت النهرَ،
في الحرائق الهائلة التي أعقبتْ هذه
الحروب،
في أعمالِ السلبِ والنهبِ المُذهلة
التي أعقبت الحرائق
وشاركَ فيها الجميعُ بسعادةٍ لا
تُوصَف.
فهذه صفة معاين، وليست تبصّرات قلب
مستغرق في العزلة، وهذه إشارات تحدّدُ
حقيقة تاريخية معروفة. والاختلاف بين
الرؤيتين، هو أنّ الرؤية التبصيرية لا
تنتمي إلى واقعنا وحقيقة حياتنا لأنّ
مصدرها الأحلام والهواتف والرؤى وقوة
العلم اللدنيّ، على حين أنّ الرؤية
البَصَرية تنقذفُ في الواقع لمعاينته
من الداخل، وتغوص في أعماقه لتراقب
حركته الدائبة.
إنّ الحواس الجسدية تنشط في هذه
القصائد، بخلاف الإحساسات الصوفية
التي تُوقفُ عملَ تلك الحواس، فالحواس
تشعر هنا إلى حدّ بلوغ لحظة الوعي،
فليس ثمة استغراق خارج تلك الإحساسات
المنبثقة من حواس تعي ما تشعر به،
وتحيلُ تجربة الإحساس إلى تجربة وجود
بعد أنْ كانت، عند المتصوفة، مجرد
خواء وعدم:
أظنُّ أنّكِ مَن منحني هذه الأصابع؟
لا
لأنّها لا تكفُّ عن تذكّر ِجسدكِ
البضّ
ولا تكفُّ عن الدعاء ليلَ نهار.
فحاسة اللمس، الأصابع، تعي طبيعة ذلك
الجسد إلى الحدّ الذي تشخّص فيه صفة
الإثارة "البضّ" وتستعيدها "لا تكفُّ"
باستمرار. وحاسة البصر، العين، تحوّلُ
الإبصار إلى كناية منتزعة من الماضي
الشخصي:
أظنُّ أنكِ مَن منحني هذه العين؟
لا
لأنّها تفيض بالدمعِ ليلَ نهار.
إذن، فهو الفرات
أو ذلك القارب الذي حملنا وسطَ الفرات
ووسطَ شمسِه اللامعة
وأسماكِه التي تراها العين
وتكادُ تُمْسكها الأصابع؟
فالعين غير منشغلة بوظيفة الرؤية
وتحديد المجال الحقيقيّ، وإنما تجاوزت
ذلك لتخلق لها مجالاً بلاغياً يُقرن
الدمع بالفرات الذي يخلق سلسلة
تداعيات عن النهر والشمس والسمك
والقارب. وهذا يعني أنّ وعي الحواس
مقترن بمكان بعينه وزمان محدّد، وليس
وعياً خالصاً في ذاته ومجرداً من
الزمان والمكان. فالحواس، هنا، حواس
تجريبية تحاول أنْ تَكشف فعلاً من
الأفعال اليومية والمألوفة، وتحوّل
المشاهَدَة من معناها الصوفي الصرف في
معارج الوصول والترقّي، إلى المعنى
التجريبيّ عندما تتحولُ إلى تجربة
لسانية وبلاغية لوصف تلك الـمُشاهَدَة
اليومية.
************************
* في
مرآة الحرف :
شعر: أديب كمال الدين، منشورات ضفاف،
بيروت، لبنان 2016
|

